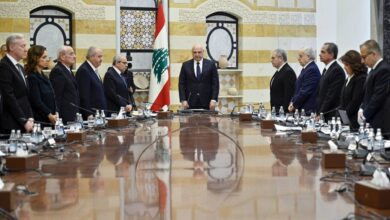نقشُ سلوان على “حجر الألف” لعمر سعيد
صدح عمر سعيد بابتهال جنائزيّ، وسال حبره مع نزيفٍ مأسويّ قاتل، عندما كتب رواية “حجر الألف”، فكانت شراعًا بوجه نزوات الرّياح، وقيثارة تعزف موسيقى الألم، والحنين، والغربة.
رواية جعلتنا نخلع صمتنا ونرتدي الكلمات، وكانت الصّفحات شاهدة على الدّموع، والتّهجير، والاغتصاب، والهرب من أنظمة لا تتّقن إلّا الغدر. هل اختار الكاتب القصص والشخصيات من الواقع المرير، أم هي التي اختارته كي يعبر بها إلى شمسٍ وحبّ؟ وأين الحبّ، والحريّة المنشودة، في خضمّ التمزّق العنيفٍ؟
نستطيع القول، أنّ رواية “حجر الألف” تخاطبنا جميعًا، ذلك لأنّنا نعيش في جغرافية منبع البؤس المتدفّق على صفحاتها، ونتجوّل في أماكن، ونجوب يوميًا شوارع، نلتقي على أرصفتها بشخصيّات تشبهنا، وتشبه شخصيّاتها، شخصيّات تجول ولا تصول في كلّ مكانٍ من وطنٍ مرشّحٍ ليكون هدفًا لتدفّق البراميل المتفجّرة، والصواريخ المعدّة لخوض حرب، مع عدو غامض، هل يمكن أن يكون نحن؟ فإذا كانت الرّواية بأماكنها وأشخاصها ليست سوى محض خيال سردي- وهذا مستبعد- فالّذين يعيشون على هامش مجتمع في اغترابهم القسري، يحتاجون إلى مساعدات جمّة، وأبسطها خدمة مترجم أمام جميع دوائر الدول المضيفة، وتنقسم أهم مقوِّمات الاندماج في المجتمع الذي ارتضوه وطنًا ثانيًا خاويًا من لغة التواصل، وهذا موصوف بإسهاب خلال السرد.
بحكم عمل الكاتب ككاتب، فقد قضى أيامه -حسب الرواية- في مساعدة العشرات من هؤلاء المهجّرين… أناس يعيشون على هامش المجتمع التركي- اليوناني، هدّت الغربة قواهم، وأضنتهم المعاناة بفعل سنوات التّهجير، ولا يزالون يحتاجون إلى مساعدة على تخطّي الواقع، وخصوصًا إلى مترجم رغم الغربة الطويلة. فالحاجة إلى خدمة الترجمة بالإضافة إلى الاغتراب والحنين إلى الوطن واللغة جمعت الكاتب مع الشخصيات بمحطات ومواقف عديدة.
ليس هناك من شخصية محوريّة أساسيّة في الرّواية، فالقصص تتشابه بحجم السّرد وتختلف بالفعل وردة الفعل. ويرى القارئ نفسه طورًا متألمًا مع المُغتصب، وتارة يكمل لحنًا لعازف انقطع وتر من آلته، ويشجّع سارق طعام الكلاب لإطعام أولاده حينًا، وفي كلّ الأحيان يلهث مع الكاتب حين كان يركض في شوارع سائلًا عن دوائر الهجرة، ويتألم وتصطك أسنانه من أخبار البرد والبؤس في مخيّم لجوء… لذلك وأنت تتصفّح هذه الرواية، تجد نفسك كمن يشاهد فيلمًا سينمائيًا بإخراج متقن، يتضمّن التهجير، والاغتصاب، والبؤس، مع “ظلم بني القربة” في الوطن قبل الهجرة. فتتحول من جالس على مقعد في الصّالة إلى شخصيّة ضمن الرواية، وكأنك أنت المُهجّر… والمُغتصب والهارب من البراميل المتفجّرة.
جعل الكاتب وعي القارئ خلال بحر السرد الواقعي الدقيق، جزءًا من حياة شخصيات الرواية، فتقاسم معه همومهم وآلامهم، وآلمتهما أتراحهم، وأسفا لتشردهم، وجوعهم وبردهم وعطشهم… وتجرّعا سوية معهم مرارة التهجير، والهروب، والغربة، والاغتراب… كما في كلّ رواية متقنة السرد، واضحة الهدف.
عند قراءتك المقطع: “في مثل هذا الأميّة، يمكنك أن تقنع الكثيرين بوجود فصيلة من البقر؛ تتكاثر بالبيوض، وفصيلة من الذّباب تتكاثر بالولادة”، تحضرك دراسة نُشرت على أحد المواقع الإلكترونية، في ما يسمى “التوالد العذري”. فقد ورد في دراسة حديثة إن أنثى فأر معدّلة وراثيًّا تمكنت لوحدها ومن دون حاجة إلى ذكر من وضع مواليد جدد. وتعتمد تقنية “التوالد العذري” المستخدمة في التكاثر، لهدف توفير عناصر جديدة، في إنشاء علاجات ضد العقم عند الرجال حيث أكد الباحثون أن “الدراسة توفر فرصًا جديدة في الزراعة والأبحاث والطب”؛ هنا تظهر الهوّة السحيقة بين الجهل المتوارث الموصوف بالرواية والعِلم الهادف.
هل أسئلة الكاتب تناقض صلاة الاستسقاء؟ وهل أنّ الموت لا ينتظر؟ وهل أنّ الحبر هو الذي يسقي قبر الجهل؟ وأي كتب ممنوعة من الدفن في أوطان متّشحة بسواد غمامة، من دون مطر، والقبر مفتوح لاستقبال كل شخصٍ غير عميلٍ كأبطال الرواية؟، “من يجفف الكاتب، إذا أمطرت سماوات كتبه؟ هل يعاني موتى القصص، والروايات من عذاب القبر والجحيم؟”!
لم يمارس الكاتب العادة السّريّة في الكتابة كي لا يخدش عذريّة المعنى والنصوص، ولم ينظّر أو يفتِ أحكامًا تتخطى هذا الكوكب، كتلك الفتوى التي صدرت عن أحد الشيوخ والتي تقول: “يجوز للمرأة أن تمارس العادة السّريّة في الجنّة؛ إذا كان زوجها منشغلًا مع حور العين”. بل عرض واقع المجتمع الذي يكبح الرغبات حتى في الخيال عندما قال: “كانوا يستمتعون، يتهامسون، ويتغامزون، ثم يضحكون، ويقهقهون إذا ما رأوا حيوانًا، يمارس الجنس، وتقوم دنياهم؛ إذا عرفوا أن أحد أطفالهم؛ يمارس العادة السّريّة، أو يقبّل فتاة”.
عندما نقرأ في بحر السرد: “في الحرب تتساوى مؤخّرات الذّكور بفروج النساء، فالقوّة الغشيمة تصنع مقاتلين قادرين على نكح الدّجاجة، قبل التهامها إذا جاعوا”، نعود بالذاكرة إلى تلك الفتوى التي حلّلت اللواط من أجل الجهاد. فأين الفرق بين الحريّة والحوريّة في مجتمع لا يصبو إلى الإنسانية؟
لم يحشر عمر سعيد اللّغة مع شخصيات الرواية، بل جعلها شخصيّة مميّزة داخل كل نصٍ، وأفرد لها نصًا كاملًا احتلّ بجدارة حوالي خمس صفحات، يبدأ بالآتي: “تشمل ملكيّة الّلغة بالإضافة إلى أبجديّتها الإنسان، والعقل، والفكر البشريّ وصندوق النطقّ، والتّنفس”، فاللغة تعتبر الشعاع الذهبيّ الذي ينير الشعوب من أجل وحدتها، ومخزن تراثها وثقافتها؛ فقول الشيخ إبراهيم اليازجي” تتراجع اللغة وتنحطّ بتراجع المتكلّمين بها وانحطاطهم، فالعيب ليس فيها. “يذكّرنا بالّلغة الهجينة (الفايسبوكية) التي تُكتب بالحروف الأجنبية، لتُلفظ بها أعرق لغة أسست وجودنا؛ فإذا كانت الّلغة كما يقول شربل شربل: “من أهم عناصر تكوين الأمم، وبلورة شخصيتها، وحفظ تطوّرها” فنحن أمّة لا شخصيّة لنا سوى التبعية، وقد أثبتت وسائل التواصل الإجتماعي، بأنّ أغلبيتنا تنتمي إلى مجتمع هجين على غرار الّلغة (الفايسبوكيّة)، أو لغة (المستغربين) -من كلمة غرب- المخلوطة عدّة كلمات من الأجنبيّة وأخرى من العربيّة، كالشوربة البحريّة التي تضمّ أنواعًا عدّة من الحبوب، ويختفي طعم كل نوعٍ في الخليط، وتعطي الدفء الآنيّ الذي لا يصل حتّى إلى الطبقة الأولى من الجلد، ويبقى البرد في العظام.
يا ليتنا نعود إلى زمن ما قبل المسيح، يوم كان للعامل الشكر مع أجره المستحق؛ فكم أن حجر الألف الذي أنهى به عمر سعيد روايته، شبيه بحجر سلوان، ذاك الحجر الذي حمل نقشًا يخلّد فيه مشروع حفر نفق اِستُخدم لجر مياه نبع أم الدرج إلى داخل أسوار مدينة القدس؛ ولم يُذكر في نص النقش اسم متعهد تولى المشروع، ولا اسم ملك حُفر النفق على أيامه، بل حفظ جهد العمال المساكين والفقراء. ولم يفطن الحكّام والمتسلّطون إلى هذا النص، إلّا حين العثور عليه عام 1880 للميلاد أيام حكم الدولة العثمانية على القدس، وقد قُطع الحجر الذي يحتويه في العام 1891 للميلاد من قبل مجهول، ورُمّم النص ونُقل إلى متحف إسطنبول، ولا يزال هناك مقطع ناقص من النص بعد الترميم، هذا النقش وضع خلافًا بين علماء مجتمعين، المجتمع اليهوديّ الذي يجزم علماؤه بأن النفق شُقّ على عهد الملك حزقيا، حيث يلائم نص نقش سلوان عدّة نصوص من الكتاب المقدّس التي تناولت مشاريع حزقيا ملك يهوذا: “وَبَقِيَّةُ أُمُورِ حَزَقِيَّا وَكُلُّ جَبَرُوتِهِ، وَكَيْفَ عَمِلَ الْبِرْكَةَ وَالْقَنَاةَ وَأَدْخَلَ الْمَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَمَا هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّامِ لِمُلُوكِ يَهُوذَا؟”، (٢ مل: ٢٠، ٢٠)، والعلماء العرب الذين نقضوا هذه المقولة بعدّة نظريات. لكن وجه الشبه بين رواية “حجر الألف” ونقش سلوان، هو أنّ الرواية نقلت الحقيقة التي تحفر في العقول أجمل النقوش الهادفة إلى تسليط الضوء على البؤس، بعيدًا عن إنجازات وهمية للحكام، ونقش سلوان الذي خلّد حفر نفق من أجل إيصال ماء الشرب للمجتمع العطش، من دون ذكر حاكم أو متعهد تابع له.
قارئ عمر سعيد ما يزال ينتظر رواية جديدة كروايات: “سوق الملح”، و”حكي تنّور”، و”حجر الألف”، ولو خيّر لاختار الّا يقرأ شيئاً، وإنّما فضّل الوقوع في غيبوبة عن القراءة، بانتظار رواية جديدة يخطّها عمر سعيد بعنوان “الطريق إلى عنّايا”، وكنت لأفعل مثله، لكنّ حبّ القراءة يمتلكني.